عُـمـى الألــوان
Colour Blindness
الألوان ضرورية في حياتنا اليومية وتؤثر علينا - فاللون الأزرق يُريحنا والأحمر يُوترنا - و تضيف الألوان إلى حياتنا طابع خاص لا أستطيع أن اشرحه سوى أن أقول لكم تخيلوا الحياة أبيض و أسود فقط! فماذا تكون حالنا؟Colour Blindness
أشعة الشمس تتكون من 7 ألوان - تسمى ألوان الطيف، وهي :
o بنفسجي Violet.
o لازوردي Indigo.
o أزرق blue.
o أخضر Green.
o أصفر Yellow.
o برتقالي Orange.
o أحمر Red.
كل لون من ألوان الطيف هو عبارة عن موجات طاقة كهرومغناطيسية ElectroMagnetic Energy waves له طول موجة Wavelength مُختلفة - وهذا ما يُعطيها الألوان المُختلفة كل حسب طول موجته.
يُمكننا أن نرى ألوان الطيف السبعة و ذلك بتسليط أشعة الشمس على مخروط من الزجاج بحيث يتحلل ضوء الشمس إلى ألوانه السبعة - لأن سرعتها سوف تختلف وهي تمر عبر المخروط لإختلاف طول موجاتها (طاقتها).
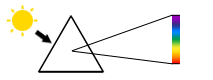
تتكون الأجسام من جزيئات - و الجزيئات تتكون من ذرات Atoms وإلكترونات Electrons - وهذه الذرات والإلكترونات تتفاعل مع الضوء (الطاقة) الذي يقع عليها بعدة طرق:
o تعكس أو تُبعثر الضوء الذي يقع عليها.
o تمتص الضوء الذي يقع عليها.
o تترك الضوء الذي يقع عليها يعبر خلالها دون أن يفقد من طاقته.
o تكسر الضوء الذي يقع عليها.
الأجسام السوداء تمتص جميع ألوان الطيف التي تقع عليها - ولهذا تبدو سوداء اللون - كذلك تكون حارة لأنها تمتص طاقة الضوء (الموجات الضوئية)- بخلاف الأجسام البيضاء التي تعكس جميع ألوان الطيف ولهذا تبدو بيضاء اللون وتكون باردة لأنها لاتمتص طاقة الضوء.
النباتات تحتوي على مادة الكلوروفيل التي تمتص اللون الأزرق والأحمر وتعكس اللون الأخضر - لهذا تكون النباتات خضراء وقس على ذلك كل الألوان التي تراها حولك.
كيف نرى الألوان حولنا؟
الإنسان يُبصر الأشياء حوله بوقوع الضوء عليها وإنعكاسه إلى العين ليقع على الشبكية التي تحول طاقة الضوء إلى إشارات كهربائية تعبر إلى المخ عن طريق العصب البصري والذي بدوره يترجمها إلى ما نراه من حولنا وبالألوان - في شبكية العين يوجد نوعان من المُستقبلات :
o العُصيات Rods : وهي مسئولة عن البصر الأبيض والأسود ونستخدمها أكثر في الظلام
o الأقماع Cones : وهي مسئولة عن البصر بالألوان أو رؤية وتمييز الألوان عن بعضها البعض - والقمع إما أن يحتوي على صبغة حساسة للأزرق أو الأحمر أو الأخضر - ويمتص موجات الضوء ذات طول مُعين- فالأقماع التي تمتص موجات الضوء القصيرة تمتص الضوء الأزرق (تميز اللون الأزرق) - والأقماع التي تمتص موجات الضوء المتوسطة تمتص الضوء الأخضر (تميز اللون الأخضر) - والأقماع التي تمتص موجات الضوء الطويلة تمتص الضوء الأحمر (تميز اللون الأحمر).
اللون الأزرق والأحمر والأخضر هي الألوان الأساسية التي تتكون منها جميع اللوان - فبإثارة تركيبات مُختلفة من هذه الأقماع نرى الألوان بإختلافها و تنوعها من حولنا.
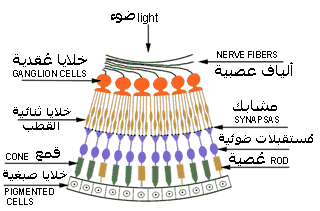
تركيب شبكية العين في الإنسان و تبدو العُصيات و الأقماع
عُمى الألوان - الاسم العلمي achromatopsia- هو عدم القدرة على رؤية بعض الألوان والتمييز بينها - أو عدم القدرة الكاملة على رؤية أي لون ة- وينتج عن نقص في إحدى أنواع الأقماع أو غيابها جميعاً .
عُمى الألوان مرض وراثي - أي ينتقل عن طريق الصبغات الوراثية (الكروموسومات) Chromosomes - وينتقل عن طريق الصبغة الوراثية الجنسية Sex Chromosomes بصفة وراثية مُتنحية Sex Linked Recessive . لهذا السبب يُصيب عُمى الألوان الرجال أكثر من النساء - لأن تركيبة الذكر الكروموسومية هي XY و تركيبة المرأة الكروموسومية هي XX - والمرض ينتقل عن طريق الكروموسوم X بصفة مُتنحية و إحتمال إتحاد كروموسومين X مُصابين بالمرض ضئيل جداً مما يؤدي إلى إصابة الرجال أكثر من النساء.
أنواع عمى الألوان :
هنالك 3 أنواع من عُمى الألوان هي الأكثر شيوعاً :
o عُمى الألوان الأحمر - الأخضر Red-Green Colour Blindness :
o هو الأكثر حدوثاً ببين الناس - ويُصيب تقريباً 8% من الرجال وأقل من 1% من النساء - وينتج عن غياب الأقماع الحساسة للون الأحمر أو اللون الأخضر.
o عُمى الألوان الأزرق - الأصفر navy-Yellow Colour Blindness :
o وينتج عن غياب الأقماع الحساسة للون الأزرق وهو نادر الحدوث.
o عُمى الألوان الكامل Total Colour Blindness :
o وينتج عن غياب الأقماع تماماً من شبكية العين حيث تحتوي على العُصيات فقط - حيث لايرى المُصاب سوى بالأبيض و الأسود و هو مرض نادر جداً جداً.
الــتــشــخـيــص
يكون من شكوى المريض بعدم القدرة على رؤية بعض الألوان والتمييز بينها – ولكن قد لا يشتكي المريض من ذلك - وباستخدام اختبار إشيهارا Ishihara Test و ذلك بعرض أرقام مُكونة من بقع مُلونة بألوان مُختلفة في لوحات تحتوي على بقع مُلونة و قياس قدرة الشخص على تمييز و قراءة الرقم من بين هذه البقع. انظر الصورتين التاليتين و حاول قراءتهما.
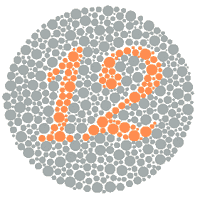
الأشخاص ذوي البصر بالألوان الطبيعية يرون الرقم 12 بالألوان - والمُصابين بعُمى الألوان الكامل يستطيعون قراءة الرقم 12 كذلك - أبيض و أسود
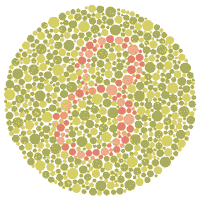
الأشخاص ذوي البصر بالألوان الطبيعي يرون الرقم 8 بالألوان - أما الأشخاص المُصابون بعُمى الألوان الأحمر-الأخضر فإنهم لايرون الرقم 3- أما الأشخاص المُصابون بعُمى الألوان الكامل لا يستطيعون قراءة الرقم بتاتاً.
هـل يــوجـد عـــلاج؟
بما أن الحالة وراثية و تنتج عن غياب الأقماع المسئولة عن البصر بالألوان من شبكية العين - عليه لا يوجد علاج لعُمى الألوان حتى يومنا هذا- و هذا يُشكل لهم مشكلة عند الإلتحاق بوظيفة